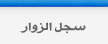الصفحة الرئيسة @ المقال الشهري @ المنْطلقات العقديَّة لدراسة تاريخ التربية
مقال شهر جمادى الأولى 1438هـ
المنْطلقات العقديَّة لدراسة تاريخ التربية
الحمد لله الخالق البارئ المصوِّر ، الذي أحسن كلَّ شيء خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ به – سبحانه – من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، ونصلِّى ونسلِّم على خير خلْق الله تعالى ، ومُصطفاه من أنبيائه ورسله ، سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد فإن المقْصود من عنوان تاريخ التربية ، أو ما يُطْلق عليه : مقدمة في التربية ، أو مدخل إلى التربية ، وربَّما وُجد تحت عنوان الأساس التاريخي للتربية ، كلُّ هذه العناوين تتحدَّث بصورة مباشرة – في جوانب رئيسة منها - عن الإنسان من الوجهة التاريخيَّة ؛ ابتداءً من واقع وجوده ، ومروراً بأحوال تطوُّره عبر الأزمان المُتعاقبة ، وانتهاءً بتاريخه الحديث ، وما يتبع ذلك من الحديث عن رجالات الفكْر والفلسفة ، ممن كان لهم أثرٌ ما في حياة الشعوب والأقوام .
وعلى الرغم من أهميَّة هذا الموضوع من الوجهة الدينيَّة ، عند كلِّ أصحاب الديانات السماويَّة – كما هو مفْروض - فإن قدْراً كبيراً من الظنِّ والخرْص والوهم : يكْتنف الحديث عن حقيقة تاريخ الإنسان ؛ لأن جزءاً طويلاً من تاريخه كان ولا يزال محْجوباً ضمن عالم الغيب ، لا سيما في الفترات التاريخيَّة السحيقة ، فيما قبل مراحل التدوين التاريخي للوقائع والأحداث ، إذ لا سبيل إليها إلا من خلال الوحي الصادق الصحيح ، بواسطة أنبياء الله الكرام - عليهم جميعاً الصلاة والسلام - الذين رافقوا – بالدعوة والشهادة - جميع المجتمعات الإنسانيَّة ، من أوَّل ظهورها إلى أن خُتموا بسيِّدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم .
والعجيب أن غالب الخرَّاصين في هذا المجال : هم من المنْتسبين إلى أهل الديانات السماويَّة السابقة ؛ من يهود ونصارى ، ومن ربَّما قلَّدهم من الباحثين المسلمين المعاصرين ، بعلمٍ منهم أو بجهل ، فيشوِّهون تاريخ الإنسان القديم ، ويصفونه بأبشع الأوصاف ؛ من الانحطاط الخلقي ، والهمجيَّة السلوكيَّة ، والتخلُّف العقلي ، وفوق ذلك كلِّه : يجْزمون بضلاله الدينيِّ والعقدي ، فهو عندهم إنسانٌ فاقد الهويَّة الدينية ، قد أمضى فتراته الحجريَّة الساحقة ، في غياهب الأديان الوثنيَّة ، التي تُلائم عصْره المُتحجِّر ، ضمن مجْتمعات بشريَّة ضالَّة ، فلا يعْدو الإنسان القديم – في نظر هؤلاء - أكثر من حيوان ذكي ، يفوق في ذكائه - المُتنامي والمتطوِّر - جميع المملكة الحيوانيَّة مِن حوله ، فهو عند بعضهم من أصل حيواني متطوِّر ، وعند الآخرين خلْقٌ ناقص بليدٌ متحجِّر ، وكلا الفريقين يحطُّ من قدْره ، فيُجْمعان جميعاً على انْحطاطه وهبوطه ، عن مرْتبة الإنسان في عصوره المتأخِّرة والحديثة .
ولئن كان لغير الباحثين المسلمين عذرٌ بالجهل ، في شأن أصل الإنسان ونشأته ، من جهة ضياع وثائقهم الدينيَّة أو تحريفها ، أو ما قد يكتنفها من الغموض ؛ فإنه لا عذر للباحث المسلم في هذا المجال ؛ بأن يختار لنفسه رأياً غير ما أوحى به الخالق جلَّ وعلا ؛ فإن الحديث عن نشأة الإنسان الأوَّل ، وما رافق هذه النشأة الفريدة من أحوال وأحداث وقضايا ، كلُّ ذلك مضبوطٌ ومحكمٌ بوثيقة قرآنيَّة صادقة ، لم يتطرَّق إليها شكٌّ قطُّ ولا ريب ، ولن يكون ذلك ممكناً في مسْتقبل الأزمان ، فمن المعيب حقًّا : أن يتناول باحث تربويٌّ مسلم ، قضيَّة غيبيَّة ماضية ، قد أصبحت في ذمَّة التاريخ ، فلا يعود بها إلى أصول وثائقها الصادقة المُتاحة ، وإنما يعود بها إلى ظنونٍ وأوهامٍ من آراء القوم الضالِّين ، فيها ما فيها من الشكوك العقليَّة المضْنية ، والأوهام العقديَّة المُفْزعة ، والإغلاقات الفكْريَّة المُخْجلة ، مما لا تقوم به قطُّ حجَّةٌ تستريح لها النفس ، ولا يحصل بها علمٌ يستقيم به الدرْس ، على نحو ما صرَّح به المؤرِّخ الحائر هربرت جورج ويلز ، في كتابه : ( موجز تاريخ العالم ) ، وهو يتحدَّث – باضطراب - عن بداية نشأة العالم ، حيث يقول : «...إن قصة عالَمِنا لا تزال بتراء ، يعتورها النقص ، وجمهرة الناس اليوم يرون : أن العالم الذي نعيش فيه - فيما تشير إليه الظواهر - كان موجوداً طوال حقبة هائلة من الزمن ، وربما لم تكن له بداية...» .
إن هذا التعبير المفْعم بالحيْرة والتردُّد والشكوك والتناقض ، وقد ضاق به عقل المؤرِّخ ، وأُغْلقت به نفسه ، حتى كتب بقلمه ما يستحي من مثله المراهقون الصغار ، فيُلْقي – في الوقت نفسه - الفكْرة التاريخيَّة وضدَّها ، في مسألة إنسانيَّة تاريخيَّة كبرى ، بل هي - في الحقيقة - أكبر المسائل التاريخيَّة وأخْطرها على الإطلاق ، فينْطلق يُقرِّر حيْرته المزْعجة ، ويبث شكَّه المُقْلق ؛ ليكون ذلك علماً يسْتحقُّ النشر ، ومعرفة تسْتوجب النظر ، وهي - في الحقيقة – لا تعدو أن تكون عباراتٌ قاصرة قاصية ، تنمُّ عن ضلال عقديٍّ كامل ، وقصور فكْريٍّ مُطْبق ، على نحو ما يسِمون به – حسب زعمهم – شعوب العصور الحجريَّة الهالكة ، إضافة إلى الدلالة الواضحة ، بحجم الجهالة التاريخيَّة القديمة .
ولئن كان لشعوب العصور الحجريَّة عذرٌ في تيههم العقدي ، وضلالهم الفكري – حسب ما يزْعمه هؤلاء – فأيُّ عذر بالجهالة تُراه يُقْبل من باحثين مرْموقين – كما هو المفْروض فيهم - فيما يُسمى بعصور النور والتنْوير ، وهم يتيهون في أهم وأكبر قضايا التاريخ الإنساني ؟! في الوقت الذي يعتبرون فيه شكوكهم العقليَّة ، وعبارات تردُّدهم العلمي : مادة للنشر والتداول ، غير آبهين بعقول مسْتبصرة ، ولا مكْترثين بنفوس مهْتدية ، تعرف بيقين حقيقة النشأة الأولى ، من خلال الوحي القرآني المبارك ، مع ما بقي بين يدي القوم ، في كتبهم التي يُقدِّسونها ، من إشارات صريحة لأصل الإنسان ، مُتفرِّداً بخلْقة ربَّانية مُسْتقلَّة عن سائر عالم الحيوان ، فمن أعْرضَ عن هذا التصريح التاريخي في كتابه المقدَّس ، واخْتار عليه الخُروص السقيمة ، واستبْدله بالظنون المخْجلة : فهو لما مع المسلمين من الحقائق التاريخيَّة اليقينيَّة أعْرضُ وأكْفر .
إن من الخطأ الفاحش : الربط - غير المعقول - بين تخلُّف الإنسان المادي في العمارة والصناعة والتجارة ونحوها ، وبين تخلُّفه العقديِّ والعقلي والسلوكي ؛ بمعنى أن المتخلِّف حضاريًّا ، لا بدَّ أنه – في الوقت نفسه – متخلِّفٌ عقليًّا ودينيًّا ، وهذا التصوُّر المقيت ينْدرج ضمن الفُحْش الفكْري ، الذي تأباه العقول الصريحة ، وتُنْكره الأحداث التاريخيَّة ، وترفضه الوقائع الحياتيَّة ؛ فقد يفْقد العالِم الكبير المتخصِّص أجْهزة بحثه العمليَّة ، ويُحْرم مجالات عمله الميدانيَّة ، فيتعطَّل تماماً عن عطائه العلمي ، ومع ذلك لا يفقد – بين الناس - مقامه في المعرفة ، ولا مرتبته في التخصُّص ، كما أن المخبول في عقله ، لو أُتيحت له المعارف بأقسامها ، وتيسَّر له العلم بأنواعه ، وقُدِّم له الدرس بمختلف طرقه وأشكاله : ما انتفع من ذلك بشيء ، بل إن أذكى الناس ، وأقدرهم على العطاء الفكري ، وأبلغهم في الإنتاج العلمي : قد يسْتسيغ عبادة الصنم ، أو تقديس البقر ، أو تأليه البشر ، فلا يرى غضاضة ، ولا يسْتشعر شيْناً في الجمع - في وقت واحد - بين أذكى المسالك وأغباها ، وبين تفوُّق العقل وضموره . وهكذا الإنسان دائماً ، هو ذاته الإنسان لم يتغيَّر ولم يتبدَّل ، فهو ما زال على أصل فطرته البشريَّة الأولى ، في كلِّ عصر من عصوره المختلفة ، وفي كلِّ موضع من مواضعه الأرضيَّة المتنوِّعة ، في السابق واللاحق : يحمل في ذاته – بصورة دائمة - كلَّ مقوِّمات الإنسانيَّة وقدْراتها ، ابتداءً من القدْرة على التعلم والتعليم ، واكْتساب المهارات المختلفة ، وتبنِّي الأفكار والمعتقدات ، وانتهاءً بالقدْرة على الإنتاج والعمارة والصناعة ، ومن ثمَّ بناء صروح الحضارة ، وما يتبع ذلك ويتخلَّله من قدرته الأصيلة على تحمُّل مسئوليات التكاليف الدينيَّة ، فكلُّ مراحله السابقة ، وأجياله المتعاقبة ، لم تغيِّر من كينونته الإنسانيَّة الأصيلة شيئاً ، فالإنسان المعاصر هو عين الإنسان في العصور السابقة واللاحقة ، وما يطرأ عليه من تغيُّر في اعتقاداته وتصوُّراته ، وفي أخلاقه وسلوكيَّاته ، وفي أفكاره وآرائه ، وفي لغاته وتعبيراته ، وفي ملْبوساته وهنْدامه ، وفي آلاته وصناعاته .. كلُّ ذلك لا يُغيِّر من جوهر الإنسان شيئاً ، فهو على ما كان عليه في السابق ، وسوف يكون كذلك أيضاً في اللاحق ، ولهذا اتحدت كلمة الرسل والأنبياء جميعاً – عليهم الصلاة والسلام – في أصول التكاليف الدينيَّة ، التي بُعثوا بها إلى أقوامهم ، وإنما وقع شيء من التنوُّع - فيما بينهم - في بعض التشريعات ، التي لا تُفيد تغيُّراً في جوهر طبيعة الإنسان المسْتعدَّة للتكليف ، والمبْنيَّة – في أصلها – على أهليَّته العقليَّة ، وقابليَّته – منذ أول الخِلْقة – للتقدُّم والإنجاز الحضاري ، فقد أُهْبط أبو البشر آدم - عليه السلام – إلى الأرض ، وقد خزن الخالق العظيم فيه من العلوم والمعارف ما الله تعالى به عليم ، فلم يكون يُضير آدم في عقله ، ولا في دينه ، ولا في علمه ، أن يبدأ بناء الحضارة الإنسانيَّة من أولها ، وأن يؤسس للعمارة الأولى من أصولها الأوليَّة ، دون سابق تجْربة ينْسج على منوالها ، أو إنجاز متقدِّم يقيس عليه ، وكذلك بنوه من بعده ، هم على شاكلته في كلِّ ذلك : (...فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ...) (30/30) .
وبناء على ما تقدَّم : فإن الباحث المسلم في مجال تاريخ التربية ، وما يلْحق بهذا التاريخ من قضايا الإنسان الإيمانيَّة المختلفة : يجب عليه – وهو يخوض غمار هذه المفازة العقديَّة الخطيرة – أن تنْتصب بين عينية سبعة منطلقات أساسيَّة ، تحكم بحثه ، وتُرشِّد رأيه ، وتضبط مساره ، وفق المقْتضيات الإيمانيَّة ، المتضمَّنة في القرآن الكريم ، والسنة المطهَّرة ، وذلك على النحو الآتي :
1) المنطلق الأول : أن الله تعالى هو وحده خالق الأكوان ، فهو المالك لكلِّ موجود ؛ ومقْتضى هذا الملك يستلزم - بالضرورة - حقَّ التصرُّف فيه بالحكم والتشريع لعبيده كلِّهم ، من أوَّلهم إلى آخرهم ، في كلِّ مراحل تاريخهم البشري الطويل ، فمن شرَّع للناس – في أيِّ زمان أو مكان - بغير إذن من الله : فقد نازع الله تعالى سلطانه ، فهو بذلك وكلُّ من طاوعه يحيون في سخط الله تعالى .
2) المنطلق الثاني : أن الله خلق الإنسان لعبادته ؛ بمعنى أن مسئوليَّة المكلَّفين جميعاً ممارسة العبوديَّة ، وفق ما بلغهم وصحَّ عندهم من التشريع الإلهي ، فمن لم يعبد الله تعالى من الأقوام السابقين ، وفق ما شرعه لهم : فقد خرج عن الغرض الأساس لوجوده ، وأصبح في موضع لعنة الله وسخطه .
3) المنطلق الثالث : أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم : كاملاً مكمَّلاً ، كأحسن وأفضل ما تكون الخلْقة الآدميَّة في أصلها الأوَّل ، من جهة : الهيئة العامة ، والعقل الراشد ، والعلم الواسع ، والعقيدة الصحيحة ، ثم امتحنه بالتكليف الأوَّل ، فما لبث أن أخفق فأكل من الشجرة الممنوعة ، فكان قضاؤه الهبوط إلى الأرض ، ليبدأ الإنسان نمطاً جديداً من التكاليف الشرعيَّة ، ويخوض ساحات أخرى واسعة من الابتلاءات ، فينقسم الناس في ذلك بين مؤمن وكافر ، صالح وفاسد .
4) المنطلق الرابع : أن الله تعالى سخَّر للإنسان كلَّ ما في الكون ؛ ليستعين بذلك على حُسن عبادته ، ويعمُر الأرض وفق نهج هدايته ، فيسْتوعب مُدْركاً – من خلال الوحي المُنزَّل - حقيقة التسخير الكوني ، ونظام سننه الطبيعيَّة ، في علاقاته بما حوله من الموجودات المختلفة ، فكلُّ ذلك من أجله ليُحْسن العبادة ، فمن جهل من المكلَّفين مفهوم التسخير وغايته ، وتاه عن نهج هدايته ، وفرَّط في مسئوليَّة عبادته : ضلَّ سعيه ودأبه في الحياة الدنيا ، ولم تنْفعه في ذلك إنجازاته الحضاريَّة ، ولم تشفع له إنشاءاته المعماريَّة .
5) المنطلق الخامس : أن الله تعالى خلق الإنسان كائناً متفرِّداً ، بلا شبيه يُقاس عليه ، ولا مثيل يُحاكم إليه ؛ فليس هو ملكٌ من أقسام الملائكة ، ولا حيوانٌ من طوائف الحيوانات ، ولا شيطانٌ من أنواع الجانِّ ، فمن رام تصنيف الإنسان خارج المحدود البشري : فقد ضلَّ بذلك عن سواء السبيل ، وخرج بالإنسان عن طبيعته الفطريَّة ، التي خلقه الله تعالى عليها ، وأسقط عنه بذلك مسئوليَّاته التكليفيَّة ، التي شُرعت – من أصلها – للإنسان ، دون سائر المخلوقات .
6) المنطلق السادس : أن الله تعالى ما زال يبعث - في الناس المُتعاقبين على الأرض - رسلاً مُبشِّرين ومنْذرين ، منذ آدم حتى محمد صلى الله وسلم عليهم جميعاً ، فشمل البعث الإلهي كلَّ قومٍ دبُّوا على الأرض ، فيُخاطبون بما يعقلون ويُدْركون ، من أنواع التكاليف الإيمانيَّة والتشريعيَّة ، فكانت السنة المطْردة في هؤلاء الأقوام هو الانقسام ؛ بين مكذب ومصدِّق ، جاحدٍ ومؤمن ، ثم كانت – بناء على ذلك أيضاً - السنة الإلهيَّة الماضية والمطْردة في هذا ، هو هلاك المكذبين ، ونجاة المؤمنين .
7) المنطلق السابع : ضرورة الوعي الجازم بواقع وطبيعة الصراع الدائم والمستمر : بين الحقِّ والباطل ؛ بين أهل التوحيد والإيمان ، وبين أهل الشرك والكفْران ، فهذه سنةٌ اجتماعيَّة ماضية مطْردة ، لم تتخلَّف عن أهل أولِّ الزمان ، ولن تتخلَّف أيضاً عن أهل آخر الزمان ، وهذا المفهوم يستلْزم الاعتقاد بدوام وجود الحقِّ وأهله ، بإزاء وجود الباطل وأهله ، وما قد يعتري حجَّة أهل الحقِّ من ضعف في بعض الأزمان : لا يُبطل حجَّة الله على المكذبين .
إذا تقرَّرت هذه المنطلقات العقديَّة السبعة في خَلَد الباحث التربوي المسلم ، وما يلْحق بها من مستلْزمات ومفاهيم شرعيَّة ، وما يتْبعها من آداب وأخلاق علميَّة ؛ فإنه غالباً ما يُحْكِم أداءَه العلميَّ في هذا المجال ، وفق ما ثبت من أخبار الوحي التاريخيَّة ، فيتجنَّب معايب البحث العلمي في عالم الغيب ، فلا يقع في الأوهام والخُروص والظنون ، التي تشين أصحابها ، وتزْدري أهلها ، وتحطُّ أتباعها ، حتى وإن كانوا علماء مرْموقين ، أو بحَّاثة مشْهورين : ( وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (53/28) .